إصدار كتاب للدكتور عمر رحال بعنوان ” النظام السياسي الفلسطيني: المعيقات البنيوية والسياقات السياسية في مسار بناء الدولة المدنية التي نريد “

رام الله- البيادر السياسي:ـ صدر عن مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية “شمس” كتاب جديد للدكتور عمر رحال أستاذ العلوم السياسية ، بعنوان، “النظام السياسي الفلسطيني: المعيقات البنيوية والسياقات السياسية في مسار بناء الدولة المدنية التي نريد”. يتكون الكتاب من (160) صفحة من الحجم الكبير ويحمل الرقم المعياري الدولي رقم ISBN 978-9950-8602-0-9 .
الدولة المدنية، كما يتناولها الكتاب، هي الإطار السياسي الذي يوازن بين الحرية والعدالة، وتستمد قوتها من إرادة الناس ورضاهم، حيث تكون المواطنة معيار الانتماء الوحيد، وتعلو المؤسسات على الأفراد، ويظل القانون فوق الجميع. باعتبارها فكرة إنسانية عميقة تنبع من إيمان المجتمع بكرامة الفرد وحريته، وتقوم على أن السلطة وسيلة لخدمة الناس لا غاية بحد ذاتها، وتُبنى على عقد اجتماعي عادل يجعل من العدالة والمساواة أساس استمرارها. وهي دولة تحمي التنوع والاختلاف باعتبارهما ثراءً، وتفتح المجال أمام المشاركة الشعبية الواعية، فيصبح المواطن شريكاً في صناعة القرار لا مجرد متلقٍ له، وتغدو المؤسسات حارسة للقيم الديمقراطية وضامنة لصوت الناس وحرياتهم.
ينطلق الكتاب من استقراء مفهوم “الدولة المدنية” تاريخياً، ومراجعة للأدبيات السياسية التي عنيت في تفسير المفهوم بشكل دقيق، وقد تبين أن مفهوم الدولة المدنية لم يكن رائجاً أو حتى راسخاً في الأدبيات السياسية الغربية؛ لأن أوروبا بدأت تخطي موضوع الدولة المدنية بعد معاهدة وستفاليا عام 1648م التي أنهت حرب الثلاثين عاماً في أوروبا، ومهدت للدولة القومية مباشرةً، فقد بدأ المفهوم في الظهور من جديد ضمن أدبيات السياسة ما بعد ما يسمى “بالربيع العربي”، في إشارة لضرورة أن تُحكم الدول مدنياً،وكان المقصود الحكم المدني مقابل العسكري ، أي حكم الجنرالات، ولم يكن المقصود الدولة المدنية ، بالمفهوم السياسي والحقوقي والقانوني، أي ضمن حدود وقواعد المشاركة السياسية والتكافؤ والعدالة الاجتماعية، التوزيع العادل للثروة، واحترام الدستور والقانون، واحترام حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية، والحريات العامة والخاصة.
تقوم الدولة المدنية على القانون ، وعلى التعددية الفكرية والاجتماعية والسياسية في إطار حداثي وتحديثي ديمقراطي تنموي، أساسه الحرية بمفهومها الإنساني التقدمي، ولهذه الدولة مشروع للنهضة تسعى إلى تحقيقه. تعددت اتجاهات مفاهيمياً وتطبيقياً من جانب المنظور السياسي والأكاديمي، إن مفهوم الدولة المدنية أظهر اتفاقاً على المسمى واختلافاً في المضمون ما بين المطالبين بالدولة الدينية والدولة العلمانية. فالدولة المدنية مهما كان شكل نظامها السياسي ومحدداتها الأيديولوجية فهي تقوم على أساس حكم القانون، والفصل بين السلطات واستقلال القضاء، واحترم الحقوق والحريات وصيانتها، وعلى المواطنة الديمقراطية، والتعددية السياسية، أي أنها دولة القانون والمؤسسات.
نظراً للطبيعة الاستثنائية والتعقيدات السياسية التي تميز الحالة الفلسطينية، فإن محاولة إسقاط المفاهيم التقليدية للشرعية على هذا السياق قد تكون محل اختبار محفوف بإمكانية الإخفاق. فالواقع السياسي الذي نشأت فيه الدولة الفلسطينية فرض منظومة خاصة من المرجعيات القانونية والدستورية التي تؤسس لمفهوم الشرعية وهي أساسية لتكوين الدولة المدنية. يأتي الميثاق الوطني الفلسطيني في طليعة هذه المرجعيات، باعتباره الوثيقة التي تُعرف منظمة التحرير الفلسطينية ككيان شرعي جامع يمثل الشعب الفلسطيني بأكمله. وتُشكّل وثيقة إعلان الاستقلال ركيزة أساسية تؤكد على الالتزام بحقوق الإنسان والمساواة الجندرية، وتؤسس لرؤية دولة فلسطينية تقوم على نظام ديمقراطي برلماني تعددي. أما القانون الأساسي الفلسطيني، فهو يحدد معالم نظام الحكم النيابي، المرتكز إلى التعددية السياسية والحزبية، ويكرس مبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون والقضاء، دون أي تمييز قائم على العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو الإعاقة. وفي المحصلة، تبقى الشرعية الشعبية حجر الأساس لكل ما سبق، إذ تُستمد الشرعية الحقيقية من إرادة الشعب، باعتباره المصدر الأصيل والنهائي للسلطة والتمثيل.
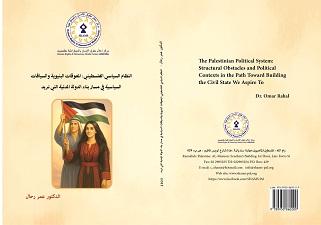
إن الدستور وحق الاقتراع العام، أصبحا مظهر هذه الشرعية الأساس في الدولة المدنية، ففي الحالة الفلسطينية أصبحت الانتخابات العامة هي المصدر الرئيسي لشرعية الوصول إلى مواقع صنع القرار في السلطة، وليس نظام “الكوتا الفصائلي” السائد في مؤسسات المنظمة، والمستند إلى الشرعية الثورية. أما المصدر الخارجي فمستمد من اتفاق أوسلو واعتراف الدول العربية وغالبية دول العالم به، الذي سبق شرعية الانتخابات وكان، ولا يزال، مصدراً مهماً ، ولكن بعد الانقسام الفلسطيني عام 2007 تعطلت الانتخابات التشريعية والرئاسية كما ولم تجرى الانتخابات للمجالس البلدية في موعدها. فقد شهدت مرحلة ما بعد اتفاق “أوسلو” تخلخلاً في النظام السياسي الفلسطيني بعناصره المختلفة، إذ يعاني النظام السياسي الفلسطيني أزمة بنيوية ، لأن الانقسام سبب وجود سلطتين واختلاف القيادة على مفهوم الإصلاح وطبيعته، وتراجع العدالة الاجتماعية، وتعزيز حضور الشركات الاحتكارية ، وتعطيل حالة التداول السلمي للسلطة، وانتهاك مبدأ تكافؤ الفرص وغياب التوازن في توزيع الصلاحيات بين السلطات في النظام السياسي الفلسطيني وتغييب السلطة التشريعية، تعثر عملية التحول الديمقراطي، العشائرية.
كل المشاكل البنيوية السابقة تعارض بشكل كامل الأسس النظرية للدولة المدنية ومرتكزاتها، التي تتمحور حول الفصل بين السلطات، سيادة القانون (مبدأ الشرعية)، استقلال القضاء، الشرعية الشعبية (الإرادة العامة)، التعددية السياسية، التداول السلمي للسلطة، المواطنة الديمقراطية، المشاركة في الشأن العام، إجراء الانتخابات الدورية، فاعلية السلطة التشريعية، احترام الحقوق والحريات العامة والخاصة، الحكم الرشيد، المساواة، العدالة الاجتماعية.
في ظل ما يشهده النظام السياسي الفلسطيني من ارتباك واضطراب، تزداد الحاجة إلى دور فاعل لمؤسسات المجتمع المدني باعتبارها رافعة وطنية يمكن أن تسهم في سد الفراغ وتصويب المسار. غير أن هذه المؤسسات، بدلاً من أن تلعب هذا الدور الحيوي، تجد نفسها في خضم حالة من الاستقطاب والاصطفاف، قد تتطور إلى الانقسام والتشظي، وربما تصل إلى حد الانشقاق عن مسؤولياتها الوطنية والمهنية والأخلاقية. في هذا السياق الحرج، تقع مسؤولية كبيرة على عاتق مجالس الإدارات، والهيئات العامة، والطواقم التنفيذية داخل مؤسسات المجتمع المدني، حيث يُفترض بها أن تتجاوز الحسابات الفئوية والمصالح الضيقة، وتنهض بدورها كمكون مستقل ووازن، قادر على التأثير وصون الثوابت الوطنية.
يناقش الكتاب مفهوم العقد الاجتماعي ويستحضر أصوله الفكرية والمفكرين الذين أطروا النظرية المؤسسة للنظم السياسية الحديثة في محاولة لإيجاد مقاربة مع الحالة الفلسطينية التي يعد أمرها غير محسوم نظراً للاختلاف مع الاتفاقيات الدولية، ومع الدستور كون الإرادة الشعبية مغيبة، والشرعية الدستورية على المحك، لا زال الشعب الفلسطيني بعيد عن فكرة العقد الاجتماعي ،وذلك بسبب عدم إنجاز مرحلة التحرر الوطني، والازدواجية في النظام السياسي ما بين مؤسسة السلطة التي تستند إلى الشرعية الديمقراطية، والمنظمة التي تستند إلى الشرعية الثورية والنضالية.
إن التقدم نحو دولة مدنية في السياق الفلسطيني لا يمكن أن يتحقق إلا عبر إرادة سياسية صادقة، وإصلاحات هيكلية جادة، ومشاركة شعبية واعية، تتضافر فيها جهود الدولة والمجتمع من أجل صياغة مستقبل يُعبّر عن تطلعات الفلسطينيين في الحرية، والعدالة، والكرامة، وبناء وطن على أسس دستورية ومؤسسية راسخة. يتضح أن تجاوز الأزمة البنيوية التي يعاني منها النظام السياسي الفلسطيني يتطلب تحوّلاً عميقاً وشاملاً في البنية المؤسسية والفكرية التي تحكمه، لصياغة مشروع وطني جديد يرتكز على مبادئ الدولة المدنية والديمقراطية، ويستجيب لتطلعات الفلسطينيين في الحرية والكرامة والسيادة. ولتحقيق ذلك، تبرز التوصيات في نهاية الكتاب ضرورة عقد مؤتمر وطني جامع، تشارك فيه مختلف القوى السياسية والمجتمعية الفلسطينية، بما يضمن شمولية التمثيل وعدالة القرار، بهدف بلورة رؤية وطنية إستراتيجية متكاملة تقود مرحلة التحرر الوطني، وتقترن بعملية تحول ديمقراطي حقيقي، يُبنى على أساس عقد اجتماعي جامع ومتماسك.
ومن أبرز متطلبات هذا التحول، انتخاب مجلس وطني تأسيسي يتولى إعداد دستور عصري لدولة فلسطين، يؤسس لمرتكزات الحكم المدني الرشيد، ويحفظ وحدة الأرض والشعب، ويُختار أعضاؤه وفق معايير موضوعية بعيداً عن الاعتبارات الفصائلية والولاءات الضيقة. كما أن احترام الاستحقاقات الدستورية، وإجراء الانتخابات في مواعيدها على المستويات كافة، يعدّ حجر الزاوية في استعادة الشرعية وتجديد بنية النظام السياسي.
ويتطلب هذا المسار كذلك إصلاحاً بنيوياً للمؤسسة الأمنية، يفضي إلى تحديد عقيدتها بشكل واضح، وتحويلها إلى جهاز وطني مهني ومحايد، ينأى بنفسه عن التدخل في الشأن السياسي، ويكرّس جهوده لحماية أمن المواطنين ومصالحهم. كما يوصى بإنشاء هيئة وطنية مستقلة للعدالة الانتقالية، تتسم بالكفاءة والشفافية، وتستفيد من التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال. تعزيز أدوار الهيئات الرقابية والحقوقية، وتوسيع صلاحيات الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان لتكون ديوان مظالم ، إضافة إلى إنشاء هيئات وطنية متخصصة تُعنى بحرية الوصول إلى المعلومات، وحقوق الطفل. وفي موازاة ذلك، تؤكد التوصيات على أهمية التركيز على التنمية البشرية، وترسيخ مفاهيم المواطنة، والمساواة، وتكافؤ الفرص، والعدالة الاجتماعية. كما يُعد ردم الفجوة بين المواطن والنظام السياسي أولوية لا بد من معالجتها من خلال سنّ تشريعات عادلة وتنفيذ سياسات شفافة تُترجم إلى ممارسات واقعية. ولا يمكن الحديث عن دولة مدنية دون استقلال حقيقي للقضاء، وضمان لسيادة القانون، باعتبارهما أساس أي منظومة ديمقراطية ناجزة.
وفي هذا السياق يجب أن تواصل فلسطين استكمال انضمامها إلى المؤسسات الدولية، والالتزام الجاد بتعهداتها القانونية، ومواءمة تشريعاتها المحلية مع الاتفاقيات الدولية، خصوصاً المتعلقة بحقوق الإنسان. كما ينبغي أخيراً توجيه الجهد الأكاديمي والبحثي نحو تحليل الواقع الفلسطيني واقتراح حلول عملية قابلة للتطبيق، انطلاقاً من مسؤولية الجامعات ومراكز الأبحاث في تشخيص الأزمات المجتمعية وتقديم الرؤى العلمية لمعالجتها. كما تُعزز وسائل الإعلام دورها التوعوي والرقابي، لتسهم في بناء ثقافة مدنية قائمة على الحوار والمساءلة.
لقراءة الكتاب اضغط/ي الرابط





