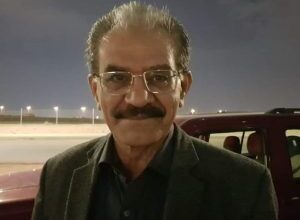المثقف وانهيار الحلم في “سيرة الزنزلخت” لخليل حسونة.. الكاتب والناقد/ ناهـض زقـوت

شكل اتفاق أوسلو وقيام السلطة الوطنية الفلسطينية، حالة من التناقض بين ذهنية المثقف وسلوكه، ففي موقف لا يرفض تحرير الوطن أو أجزاء منه، وفي موقف آخر ليس هذا ما حلم به وطرحه في كتاباته، كانت فلسطين التاريخية هي مجمل أحلام المثقفين الفلسطينيين خاصة، والعرب عامة. وجاء اتفاق أوسلو كمرحلة أولى في انهيار الحلم، وكانت المرحلة الثانية في قيام السلطة وما رافقها من مساوئ على المستوى السياسي، بالإضافة إلى وجود الاحتلال رغم شعارات التحرير، فكيف يكون الاحتلال وقيام سلطة وطنية على أرض واحدة، تناقض رفضه المثقف.
وتطرح “سيرة الزنزلخت” إشكالية المثقف الفلسطيني في رؤيته للواقع بعد قيام السلطة الوطنية الفلسطينية، حيث لم يكن هذا حلمه، إنما كان حلمه أكبر من وجود سُلطة يطوقها الاحتلال، ويطمح من خلال وعيه الممكن إلى واقع بديل يزاوج بين الحلم والواقع، بمعنى سلطة وطنية خالية من العيوب والمفاسد، سلطة تكون نموذجاً متفرداً عما يحيطها من أنظمة عربية، سلطة تؤمن بالديمقراطية وحرية الرأي والتعبير، سلطة تسعى نحو بناء المجتمع المدني بعيداً عن العسكرة والهيمنة الأمنية، سلطة تؤمن بحياة الجماهير والفقراء، سلطة ترفع عن الشعب ذل الاحتلال وممارساته القمعية.
إن أحلام المثقف انهارت تحت عجلات وجنازير دبابات الاحتلال حين عاد ليحتل ما كان محرراً، ويفرض قوته وممارساته العدوانية على شعب من المفترض أنه يحيا في ظلال سلطة وطنية تحميه وتدافع عن أمنه وأمانه. فأصبح الواقع قاسياً في كل مجالات حياته، بدءً من لقمة العيش وصولاً إلى حصار الطرق وقطعها.
عتبة العنوان:
سيرة الزنزلخت، عنوان الرواية كما نلاحظ ينقسم إلى كلمتين “سيرة” و”الزنزلخت”، إذن ما العلاقة التي تجمع بين الكلمتين؟. إن مفهوم “السيرة” على المستوى المعرفي يعني “تفسير الذات”، وفي هذا الموضع من العنوان لم تدل الكلمة على هذا المعنى، إذ لم تدل السياقات اللغوية على أن النص هو سيرة الراوي أو سيرة المؤلف، فقد ارتبطت كلمة “السيرة” بكلمة أخرى “الزنزلخت” ولم ترتبط بالمؤلف، فالسيرة هنا هي سيرة المكان الذي مثله “الزنزلخت” أو هو الواقع المر الذي يعيشه الشعب الفلسطيني في ظل الاحتلال وبعد اتفاق أوسلو.
أما كلمة “الزنزلخت” فهي كلمة اسمية وصفية لشجرة ضخمة ظليلة تتميز بمذاق ثمرها العلقم، وكانت تزرع في قطاع غزة على جوانب الطرق للزينة والتفيء بظلها. فهل لهذه الشجرة سيرة، هل هي كائن حي له سيرة وتجارب؟. إننا على المستوى المعرفي ننكر تلك السيرة لهذه الشجرة، فهي مجرد شجرة كمثيلاتها من الشجر وإن تميزت بمذاقها المر، أما على المستويين الدلالي – الاجتماعي تحمل تلك الشجرة رمزية اجتماعية، حيث تمثل واقعاً نعيشه.
في سيرة الزنزلخت، لا نستطيع الفصل بين المكان والزمان إلا على المستوى الدلالي، أما على المستوى الواقعي فثمة ترابط حميمي بينهما، على اعتبار أنهما يحملان شهادة التاريخ على الواقع الفلسطيني.
الزمان والمكان:
تأتي هذه الرواية لتعبر في أحداثها عن الزمان المتمثل بعد اتفاق أوسلو، وعودة الغائبين، وقيام السلطة الوطنية، وصولاً إلى انتفاضة الأقصى. أما المكان فهو قطاع غزة على امتداد مساحته، مستحضراً أحياناً الماضي في القرية الفلسطينية ليقارن بينها وبين الحياة في المخيم.
لم يهتم الراوي بوصف ملامح المكان وتفصيلاته، مما يشير إلى حالة الرفض لهذا الواقع الذي لم يوفر له وللآخرين الشعور بالأمان، فما زال الضباب يلف المكان، وغلالات من الدخان تطوق المكان. إن اتفاق اوسلو لم يغير المكان، فما زال “المكان يغرق وسط ظلام دامس … وبالجدلية القائمة بين المكان والزمان في السرد الروائي، نكتشف رفض الراوي للسلام القائم على اتفاق اوسلو، وبالتالي رفض الواقع الذي أفرزه أوسلو، بعد أن تبددت الأحلام والآمال وتراجعت المبادئ والثوابت.
الشخصيات:
ينهض صوت “سعاد” في نسيج المحكي الروائي، عن امرأة متزوجة من فدعوس الذي تزوجته بعد أن “رفضت الجميع من أجله”، إلا أن فدعوس تركها وهاجر بحثاً عن الولد بعد أن اكتشف أن سعاد عاقر، ولكن سعاد لم تيأس بل واصلت مشوار حياتها مستندة إلى المرأة العجوز “أم أحمد” التي اعتبرتها مثل ابنتها، ولكنها في الوقت نفسه حزينة على ما آلت إليه أمور حياتها بعد غياب فدعوس، إلا أنها سعت وراء الطفل الذي كانت تسميه “ابن العازة” والذي يمثل لها الأمل والمستقبل، في محاولة منها لاسترداد فدعوس. ويعود فدعوس من غربته طالباً الصفح والغفران ومعترفاً بخطأه، إلا أن سعاد لم تشعر بالفرح لعودته، فقد اكتشفت كم هو ملئ بالزيف والخداع، ولكنها لم تكره فدعوس، وكان أملها أن يتغير ويعود إلى قواعده سالماً، حتى تسلمه الأمانة التي وعدته بها، وتتضح صورة الأمانة في نهاية الرواية حين يتكور بطن سعاد بالأمل القادم.
وهذا التصور الذي رسمه الراوي لسعاد، ملئ بالدلالات الرمزية والرؤى الأيديولوجية، لذا يحاول الراوي أن ينفي عنها صفة المرأة، بالمعنى البيولوجي للمرأة، ما يؤكد أن سعاد تحمل دلالة رمزية أعمق من كونها امرأة بسيطة تعيش في مخيم الشاطئ.
وحينما نغوص في أعماق شخصية سعاد، وبقراءة أفكارها في المساحة اللغوية التي تركها الراوي لها أحياناً لتحكي عن نفسها، نكتشف أننا أمام امرأة تمتلك ثقافة عالية وخبرة سياسية وتجارب حياتية عديدة، وهذا لا ينعكس على سعاد، بل ينعكس على دلالتها الرمزية، التي حاول الراوي توظيفها في النص لتعبر عن منطقه وفكره، لا منطقها ورؤيتها الخاصة بذاتها كامرأة، إنها أداة الراوي في التعبير عن ذاته، وطرح أفكاره الأيديولوجية عن الواقع الجديد بعد اتفاق اوسلو.
أما شخصية “فدعوس”، تلك الشخصية التي ارتبطت بسعاد بذلك الرباط المقدس، إلا أن فدعوس لم يحافظ على سعاد، بل تركها لمصيرها تجتر الآلام والأحزان، وهاجر إلى منافي الغربة يبحث عن الأمل والمستقبل، وحين لفظه الجميع عاد إلى وطنه كسيراً، فلم يجد له ملاذاً سوى مقهى البحارة، الذي يذهب إليه كل يوم بعد عودته من عمله، ويلعب القمار، ويعود آخر الليل إلى بيته خالي الوفاض، ولم تشعر سعاد بعودته كما كانت تحلم وتنتظر، فقد عاد إليها صامتاً جامد الشعور. فما كان منها إلا اليقين أن لا حبيب لها سوى ابنها القادم، إذ أصبحت تسعى نحو الأمل والمستقبل المتشكل في ابنها القادم، لقد وصلت في ظل فدعوس العائد إلى حالة من الاضطراب والتهلهل الفكري.
إن شخصية فدعوس كما رسمها الراوي هي شخصية عبثية، لا تقيم للأمور وزناً ولا تحافظ على ثوابت: “أين المبادئ التي أقروا بها أمامنا… ورغم محاولة فدعوس التراجع عن سلوكه المرفوض من سعاد، ويبدي ندمه عما ارتكبه من أخطاء في حقها، فما كان من سعاد إلا أن أشاحت بوجهها عنه رافضة عودته، “عاد فدعوس، وفلسطين لم تعد”.
هل تخلصت سعاد من فدعوس؟، واتجهت نحو الأحلام والرغبة الجامحة، فثمة فتى محب كان يراود سعاد وحين لم يجد لديها الوصال ذوى عوده، فقد حسمت أمرها مع فدعوس ورفضت الجميع من أجله، ورغم ما حدث بينهما من خلاف في الأفكار ووجهات النظر لم تكره فدعوس، إنما حاولت أن تعيده إلى قواعده سالماً، وفي النهاية يقفان معاً في انتظار ابن العازة.
أما الشخصية الثالثة في النص فهي “أم أحمد”، وقد رسمها الراوي كأنها رأس مثلث، طرفيه سعاد وفدعوس، فهي كبيرة نساء القرية، العارفة ببواطن الأمور، والمتمسكة بالتراث والعادات والتقاليد وسيرة البلاد. لقد مثلت أم أحمد على المستوى الدلالي الرمزي، الماضي والتاريخ.
كان فدعوس على خلاف سعاد بعد عودته في الموقف من أم أحمد، فهذا العائد قد رفض التاريخ ويحاول تغييره، ويريد أن يشعر بالراحة دون مشاكل أو ثورات، فهو شخص قد استسلم للواقع، لهذا كان على موقف الضد من أم أحمد، ويتمنى موتها ليرتاح ذهنه من قيودها. إن موقف فدعوس من أم أحمد يرتبط بالمكان السردي – الواقعي وزمانه، فهو مقيد بقيود الاتفاقات التي ألغت التاريخ وزورت الجغرافيا.
وتنتهي الرواية دون أن يأتي ابن العازة، بل ما زال متكوراً في بطن سعاد أي أن الأمل لم يأت حقيقة. لقد ترك الراوي/ المؤلف النهاية مفتوحةً على سؤال كبير: هل حقاً سعاد حامل؟.
الرؤية الكلية:
وبعد أن قاربنا دلالات الشخصيات في النسيج الروائي، نحاول تركيب الرؤية السردية وفق تلك المقاربات، لنصل إلى مشروع الراوي/ المؤلف الأيديولوجي في سيرة الزنزلخت.
– سعاد: هي فلسطين أو الواقع الفلسطيني بعد أوسلو.
– فدعوس: هو الفلسطيني العائد المستسلم للواقع.
– أم أحمد: هي الماضي والتاريخ أو هي فلسطين التاريخية.
– الفتى الجميل: هو الفلسطيني الآخر المنافس على سعاد، (تنظيم سياسي ما).
– المولود القادم: هو الأمل والمستقبل، هو جيل الغد الذي يراهن عليه الراوي في إعادة ما دمره فدعوس.