المشاركة والسلوك السياسي في المجتمع الفلسطيني
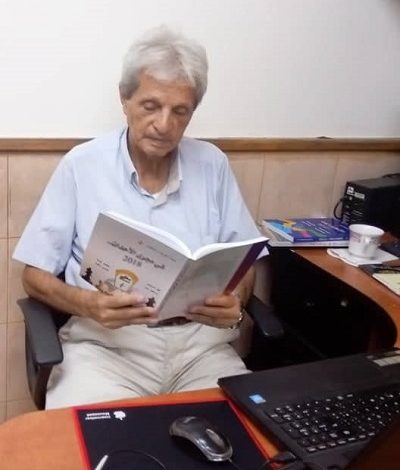
دراسة اجتماعية في أجزاء: الجزء الخامس. أنماط السلوك السياسي
أسامة خليفة
باحث في المركز الفلسطيني للتوثيق والمعلومات «ملف»
أنماط السلوك السياسي هي أشكال السلوك والنشاط التي يقوم بها الأفراد والتي تعبر عن وجهات نظرهم في المسائل السياسية المتعلقة بقضيتهم الوطنية، والتي تبرز من خلال النقاش في الحياة العامة أو في إطار سياسي منظم، أو جماعة رسمية أو غير رسمية أو خارج هذه الجماعات كلها في نمط من السلوك الغير مبالي. وهناك الكثير من أشكال النشاط السياسي التي تتباين فيها مواقف الأفراد أو تتشابه، ومنها: (محاولة التأثير على الآراء السياسية للآخرين، الانتماء التنظيمي، التصويت، التظاهر، الإضراب، وأعلى أشكالها بالنسبة لكثيرين من الشعب الفلسطيني هو الكفاح المسلح…).
النمط السلوكي هو نموذج للتصرفات والانفعالات والأقوال التي تحدد سلوكاً معيناً تجاه المسائل السياسية، وقد اختلفت الاتجاهات النظرية في موقفين من السلوك: الموقف الأول: يركز على السلوك الظاهر واهتم بدراسة وقائع السلوك الواضحة والظاهرة والقابلة للملاحظة، واستبعد البحث في مسبباته الذاتية ودوافعه الاجتماعية، فالدوافع لا يمكن ملاحظتها وبالتالي لا يمكن دراستها. والموقف الثاني: يركز على دوافع السلوك ( قيم، معايير، ميول، اتجاهات…). يعتبر ماكس فيبر السلوك ذا المعنى، هو أساس الدراسات الاجتماعية، فبذل جهده في تصنيف الأفعال الإنسانية وتنميطها، لكنه أفرط في الأبعاد الذاتية والمشاعر الفردية، فجعل علم الاجتماع أقرب إلى علم النفس.
الاتجاه البنائي الوظيفي ركز على البناء الاجتماعي ككل مترابط ومتفاعل تتبادل مكوناته التأثير والتأثر، لذلك كانت محاور هذا الاتجاه تتركز حول ثلاثة أسئلة:
ما هي الأنماط التي يمكن الكشف عنها، وإقرار وجودها عند دراسة ظاهرة معينة؟.
ما هي الظروف والمصاحبات التي يمكن أن تنتج عن التفاعل بين هذه الأنماط؟.
ما هي الوظائف التي تدلل على وجود هذه الأنماط وتبرهن على تفاعلها؟.
السلوك الإنساني فعل فردي ذو معنى، هادف يحدث بشكل مقصود وواعٍ، أو أن السلوك هو تصرف الفرد الذي يمكن التنبؤ به في موقف إنساني بموجب دلالات ترابط مجموعة من التصرفات، كيفية التصرف أو ردود فعل الفرد، إزاء موقف معين، هذا ما يميز شخصية الفرد، أما المشاركة فهي مفهوم اجتماعي للتصرف، هو التصرف الفردي من زاوية علاقته بالجماعة وتفاعلاتها أي دور الفرد في الجماعة.
أما السلوك الجمعي فهو مجمل تصرفات الجماعة خلال فترة زمنية ودلالات هذه التصرفات التي تعبر عن شخصية الجماعة التي تذوب فيها الشخصية الفردية، السلوك الجمعي هو معيار لحيوية الجماعة ومدى مشاركة أعضائها في أمورها، أما التصرف فهو مفهوم فردي لفعل في موقف محدد، وتكرار الظرف والموقف ذاته لا يعني القيام بالتصرف السابق ذاته أي لا يمكن التنبؤ بالتصرف، قد يستغرب شخص تصرفه في كيفية مشاركته الاحتجاجية في تظاهرة كأن يرجم جنود الاحتلال بالحجارة، أو يشعل النار بالإطارات، يرى أنها تخالف نمط شخصيته وطبيعتها السلمية.
يتصف السلوك أنه شخصي أي يتوقف على إنسان محدد دون غيره، مثل السلوك العنيف كرد فعل على موقف أثار الغضب، إنه أسلوب معين له خصائصه التي تميزه في التعامل مع الواقع يتبعه الفرد، وقد يدخل هذا الأسلوب في الوعي الفردي فيتحول إلى فلسفة في الحياة، الناضجون الأكثر وعياً من أتباع نمط سلوكي سياسي معين يؤثرون بغيرهم ضمن آليات التفاعل النفسي الاجتماعي.
فلسفة الحياة أو الموقف المبدئي من القضايا، يعني وعي شمولي لطريقة التصرف، لكن كل تصرف يحمل في طياته وعي جنيني بطريقة أو أخرى. إنما النموذج السلوكي يجمع ما هو مشترك بين عدد من الناس، درجة العنف الناجمة عن حالة الغضب، تميز مجموعة من الأفراد عن غيرهم ممن يتبعون أسلوباً سلوكياً آخر في ذات الموقف.
تصنيف السلوك حسب أنماط (أصناف) هو عمل نظري إذ تتداخل الحدود بين هذه الأنماط وتتباعد، فنمط المشاركة العنيفة باستخدام السلاح، ونمط المشاركة السلمية كالهتاف ورفع الرايات واليافطات في النشاطات والمسيرات والتظاهرات، قد يكون بينهما أنماط مشاركة معتدلة في تكتيكاتها ومطالبها، لكن يمكن رؤية الأنماط السلوكية المشاركة من خلال خمس مجموعات:
الواقعية:
في هذا المجال لابد من ذكر المدارس السياسية الواقعية أو نظرية الواقعية السياسية التي تفصل بين السياسة والأخلاق كالميكافيلية والذرائعية الغربية، والتي تعرضت لانتقادات شديدة، لكنها تمارس فعلياً قناعاتها وأفكارها في العلاقات الدولية دون وازع أخلاقي، والتي تقوم على المصلحة والقوة السياسية والحصار الاقتصادي والأنانية وإثارة ما يسمى الفوضى الخلاقة.
ليس المقصود في هذه الدراسة ما تقدم من نظرية السياسات الدولية الواقعية القائمة على المنافسة والصراع، بل المقصود هو النظرة الواقعية في البحث في الظروف الموضوعية، وتفسير الواقع السياسي والاجتماعي تفسيراً علمياً، هنالك موقفان في التعامل مع هذا الواقع المفسر علمياً: موقف الواقعية القدرية، وموقف الواقعية الثورية.
الواقعية نهج تحليل ودراسة وبحث، يحتمل النقاش والحوار والنقد، بما يتعلق بوصف الواقع، وتنظيم الحقائق، ورسم السياسات المطلوبة، وطرح الحلول الممكنة، وتوظيف الوسائل والأدوات المناسبة لتحقيق الأهداف، ذلك أن من يدعي الواقعية قد يخطئ في تحليل الواقع، في الحالة الفلسطينية، قد يخطئ طرف في تقييم قوة طرفي الصراع، اسرائيل من جهة، والفلسطينيون من جهة أخرى، والسؤال: هل اقتنع البعض بما طُرح بأن الجيش الاسرائيلي جيش لا يقهر؟. وهل اقتنع البعض أن اسرائيل متفوقة حضارياً وعسكرياً على العرب مجتمعين؟. أو على العكس من ذلك أنها أوهن من بيت العنكبوت؟. هذا في معادلة الصراع العربي الاسرائيلي، فكيف يكون الحال في معادلة الصراع الفلسطيني الاسرائيلي؟. ما حال ميزان القوى؟. قد تتفق الواقعية القدرية والواقعية الثورية في الإجابة على هذه الأسئلة، لكن الاختلاف يظهر في الإجابة على السؤال: هل يمكن للفلسطينيين أن يغيروا المعادلة؟. وكيف؟. الواقعية القدرية تنظر إلى الواقع نظرة جامدة سكونية، على عكس الواقعية الثورية التي ترى الواقع متحركاً متغيراً لا يبقى على حال واحدة، وبالتالي تسعى للتغيير، ورغم تمسكها بالظروف الموضوعية، إلا أنها تؤمن بدور العامل الذاتي في إحداث التغيير المطلوب، لذلك فإن العمل الثوري يرتبط بمرحلة إعداد وتصعيد ذاتي مناسب، استعداداً لمواجهات مستمرة متصاعدة.
يرفض اتجاه الواقعية الثورية تقديم التنازلات، لكنه لا يرفض التعامل مع الواقع المعطى في الوقت الذي يجري فيه تحميل المسؤولية للأفراد في مواقع عملهم من خلال القيام بسلوك محدد في جماعة ما، فليس هناك فعل اجتماعي خارج نطاق الجماعة، بما فيها الأعمال الثورية، لذلك يؤمنون بجدوى العمل في الأطر الجماعية المنظمة، كما يؤمنون بالجمع الديالكتيكي بين العامل الذاتي والعامل الموضوعي.
الراديكالية:
أصبحت الراديكالية في الفكر السياسي الليبرالي ووسائل الإعلام الغربية، بمعناها ومدلولها تشير إلى الأصولية الدينية ولا سيما الإسلامية، كما وتربط مفهوم الراديكالية بالتطرف واللجوء إلى العنف وتسميه إرهاباً، ولو كان نضاله مشروعاً، وقد كانت قبل انهيار منظومة الدول الاشتراكية، وانفراط عقد الاتحاد السوفيتي، تلصقه بالتيارات الماركسية التي أصرت على رفض الإصلاحات الجزئية، وانتهجت الفكر الثوري، واعتمدت الثورة كوسيلة وحيدة لإحداث التغيير الاجتماعي.
أصبح معروفاً إلى ما ترمي إليه الحملات الإعلامية الغربية والاسرائيلية في وصف النضال الوطني الفلسطيني بالإرهاب، وتصنيف منظمة التحرير الفلسطينية كمنظمة إرهابية، ومعها العديد من الفصائل الفلسطينية.
وبغض النظر عن هذه الحملات وغاياتها، فالراديكالي في هذه الدراسة هو من يرى في العنف وحده السلوك المجدي دون غيره من أشكال النضالي الشعبي، وشعاره ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة، رافضاً المرحلية في تحقيق الأهداف متمسكاً ببرنامج تحرير شامل وفوري، نظرة لا ترى أي رابط بين السلوك اليومي الحياتي وبين القضايا الحيوية للشعوب، يفضل الراديكالي الفعل الذي يحدث ضجيجاً مدوياً، وهو ضد أي هدنة أو تأجيل مؤقت للمواجهة مع العدو حتى يحين الظرف الملائم، فالعمل الثوري يمكنه أن يغير الظروف غير الملائمة، والانتظارية تطيل أمد الصراع وتميعه، ولا تسمح بالخروج السريع من الظروف الضاغطة، وتتعالى هذه النظرة على الفئات المغلوب على أمرها وتستصغر نشاطها، ولا تهتم بالظروف الحياتية والفوارق الفردية، تدعو إلى ترك العمل والدراسة ومشاغل الحياة المعيشية، أو الحد منها لصالح نشاط أرقى، نموذجه المثالي الالتحاق بصفوف الثورة وحمل السلاح، ويطرح الراديكالي ضرورة أن يأخذ الشعب الفلسطيني زمام المبادرة بيده، دون حاجة إلى دعم عربي، أو ظرف دولي ملائم ومناسب، وربما يرى في التدخل العربي خنقاً للمبادرة يؤثر سلباً على مجرى العمل الثوري، والمساعدة يراها في فتح الحدود العربية للفدائيين للانطلاق بعملياتها في العمق الفلسطيني المحتل، فتترافق البيانات العسكرية مع النضال الفعلي، ويصبح عمل المنظمات الفلسطينية ذا فعالية مجدية.
الرومانسية الثورية:
ظهرت أفكار الرومانسية الثورية بداية في الأدب الإبداعي المتمرد على الأدب الكلاسيكي، قبل أن تدخل دهاليز السياسة، التي يرى البعض أنها ارتبطت بحركات التحرر ولا سيما في جناحها الماركسي، والتي جعلت من تشي غيفارا أيقونة النضال والتمرد على الواقع وقيم المجتمع الاستهلاكي، وتدعو لخوض المغامرة الثورية كتجربة إنسانية حالمة بمستقبل مشرق، تزول فيه القيود وشقاء الإنسانية، بينما الأحزاب الماركسية تنعت هذه التجربة بالطفولية اليسارية التي تتجاوب للأحلام وتبتعد عن معطيات الواقع.
يتميز صاحب هذه النظرة بالاندفاع الحماسي والعاطفي للفعل الثوري، والدافع الذاتي الأخلاقي القيمي هو الكامن وراء العمل الثوري الرومانسي، لذلك تقوم القيم الأخلاقية والأحلام المستقبلية مقام الحقيقة الموضوعية، قد يكون للرومانسية الثورية فكر سياسي اجتماعي استمده من الأعمال الأدبية المبدعة، التي لم تبقَ مجرد حركة أدبية فنية، بل تطورت وتبلورت رومانسية سياسية، ورومانسية ثقافية، تناهض الفكر النفعي الذرائعي، وتناهض الحضارة الرأسمالية، لكن عملهم الثوري ليس له برنامج تكتيكي أو استراتيجي ثابت، فتصبح الثورة لأجل الثورة، والثورة مجرد شعار جميل، وتظاهر وتغني بالبطولات والتضحيات، وعلى حد القول: (أجل، قد نموت ولكنها ستكون ميتة جميلة)، ولعل وجود رومانسية ثورية فلسطينية ولدت من رحم حركة التحرر، قد تكون امتداداً للفكر الفلاحي التقليدي، وموقفه من النشاط الثوري من خلال قيم لها أهمية في ذاتها كالحمية والنخوة، فهو يدعو للثأر الفوري لامرأة تصرخ واعرباه، مهما تكن النتائج، وعندما لا يستجاب لنداء المرأة فإن القيم العربية الأصيلة قد سقطت وغاب الحس الثوري وعلينا أن ندفن رؤوسنا في التراب من شدة العار.
الهروبية:
تزعة تميل إلى الانطواء والابتعاد عن مشاكل المجتمع، من تجلياتها السياسية الاستسلامية والانهزامية، أو في المفهوم الشعبي الانبطاحية، يتميز الهروبي بالنفاق، فنادراً ما يقول الهروبي عن نفسه أنه هروبي، ترتبط الهروبية بأسلوب لفظي هو التمويه، فالهروبي قد يدعي الثورية، يُحمّل المسؤولية للأنظمة العربية، ويتحدث كثيراً عن تقاعسها تجاه تحرير فلسطين، وينفض عن كاهله المسؤولية، أو أنه يتحدث عن الدور الهام للانتفاضة لكن حماسته لها لا يعدو كونها شكلاً من التغطية على العجز والخشية، يركب فيها موجة التعاطف العام مع أبطال المقاومة، أما أقصى ما يمكن أن يساهم به هو المناصرة اللفظية المفرغة من مضمونها، وتلخص الهروبية أزمة المقاومة الفلسطينية بأنها تتعلق بطبيعة القيادة الفلسطينية حصراً، وبالتالي الهروب من الدور المطلوب بصب اللعنات على هذه القيادة، يؤدي هذا التمويه إلى فصل القول عن الممارسة، أو يصبح القول هو الممارسة بحد ذاته.
العدمية:
على العكس من الرومانسية الحالمة، العدمية فلسفة العبث والتشاؤم وفقدان الأمل، وهي نزعة نفسية أكثر منها عقلية، تقوم على الشك والتعامي عن الحقائق والوقائع، تشيع اليأس والسلبية في النفوس في كل أمر، وتشيع القلق والخوف والكآبة والإحباط، تشمل مجموعة من الآراء حول الحياة، ملخصها أن لا معنى لها، يوضحها قول المعري: (غير مجد في ملتي واعتقادي.. نوح باك ولا ترنم شادي)، وأن المؤسسات الاجتماعية لا دور ولا هدف لها وتصبح أشكال السلوك والأدوار في المؤسسة مجرد سلوك يومي نمطي رتيب، وبالنسبة لأشكال السلوك السياسي ترى النظرة العدمية أنها غير مجدية ولا يمكن الرهان عليها في حل الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي أو أن تقدم أو تؤخر فيه، أو أن تساهم في استعادة الحد الأدنى من الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، لذلك أي جهد يُبذل هو مجهود ضائع، وإصدار البيانات السياسية مجرد حبر على ورق، وعمل القيادة الفلسطينية مجرد أعمال إدارية لا ثورية، وعمل المنظمات فاقد للفعالية، والجماهير قد فقدت الحماس الثوري، وأصبحت القيم الثورية عملة نادرة، وكل أنماط السلوك التي تقوم بها الجماهير، ينظر إليها العدمي من باب الازدراء، قاصرة عن أداء أي دور يعقد عليه الآمال.
يشار في هذا المجال إلى المفهوم الحديث نسبياً (الاغتراب السياسي) الذي يعرف بأنه حالة مشاعر عميقة من احتمالات الغربة والرفض والسلبية وعدم الارتياح للوضع السياسي، الفرد الذي يشعر بالاغتراب لا يبالي بالحالة السياسية، ولا بأشكال السلوك السياسي القائمة الآن، مجدية كانت أم غير مجدية. وتبين الدراسات العلاقة بين المشاركة والاغتراب السياسي، في الامتناع عن التصويت ولو كان تصويتاً احتجاجياً.
تنشأ هذه النظرات عن عوامل موضوعية وذاتية، يتعلق العامل الموضوعي بالتغيرات السياسية والاجتماعية المحيطة، ومقدار خدمة هذه الظروف والمتغيرات للمصلحة الوطنية، وبالتالي للمصلحة الشخصية، ويتعلق العامل الذاتي بعوامل داخلية فردية، وكمثال: الوضع المحيط والظروف الصعبة إذا أضيفت إلى حالة نفسية من الاستشعار بالعجز تولد النظرة العدمية المعبر عنها بعدم الرغبة بالقيام بأي فعل ذي أهمية.
الظروف الضاغطة والواقع الصعب يؤدي إلى رفض ملحوظ للأشكال الثورية الرومانسية غير المجدية والمفرطة في الخيال والأحلام، كما رفض العدمية وسلوك الابتعاد عن الواقع وعن أي سلوك يغير الحال إلى حال أفضل، وترى الواقعية في الفعل اليومي العادي تراكمات صغيرة تؤدي إلى نتائج مهمة كأثر الفراشة، يرى الشاب بإمكانه أن يخدم قضيته من موقعه، فدوره البسيط رفيف جناحي فراشة يسبب سلسلة متتابعة من النتائج والتطورات يفوق بكثير حدث البدء، يرى الطالب خدمته لقضيته الوطنية من خلال موقعه على مقاعد الدراسة بالاجتهاد والتفوق، ويربط مستقبله الشخصي بالمستقبل الوطني بدراية وعقلانية، ويراه آخر بالعمل بإخلاص واتقان الصنعة، والمعلم يرى دوره في مجال تربية الأجيال تربية وطنية، يؤمن أن التربية قادرة على إحداث تغييرات هامة، ولها دورها في البناء والصمود في حالات النكوص والزمن الصعب.
تشترك النظرة الرومانسية والراديكالية في صفات معينة، مثل الحماس والاندفاع، وقد يكون لها دور ايجابي في الظروف الاستثنائية، لكن الهروبية والعدمية غير مجدية على الاطلاق.
وفي دراسة المشاركة والتنشئة في المجتمع الفلسطيني، تبين احصائيات الدراسة الميدانية، أن الأنماط السلوكية لا تتوزع بالتساوي على المنتسبين لتنظيم وغير المنتسبين، وهناك فروق إحصائية لها مدلولها في العلاقة بين الانتماء التنظيمي والأنماط السلوكية: إن كل حالات الهروبية تقع في فئة غير المنتسبين، وتتوزع النظرة الرومانسية عند المنتسبين الحاليين والمنتسبين السابقين (تارك) بينما تنخفض بشكل ملحوظ عند غير المنتسبين، النظرة العدمية تتوزع بين المنتسب سابقاً وغير المنتسب، أكبر نسبة للواقعية القدرية عند غير المنتسبين.
سجلت الراديكالية نسبة تواجد لا بأس بها في المجتمع الفلسطيني، إنما ولأن الراديكالي يتميز بالحماس والاندفاع، فإما أن يقوم بعمل فوري سريع وغير مدروس، وإما أن يصاب حماسه بالفتور نتيجة الاصطدام بالواقع، وقد تصل الراديكالية إلى طريق مسدود في العمل النضالي إلا في ظروف محددة الشروط، عندما لا يحتاج الوصول إلى الأهداف مكاسب مرحلية وعملاً تراكمياً طويل النفس، فكثير من الشبان الذين اندفعوا أثناء المعارك يطلبون السلاح سرعان ما فتر حماسهم، ثم غابوا في رتابة الحياة اليومية.
تبقى مسألة تعميم نسب الانتشار، وعلاقة هذه النسب بالواقع الاجتماعي المتغير وخاصة في جانبه السياسي، إذ أن تصاعد عنف ممارسات الاحتلال وإجراءاتها القمعمية، تنمي النزعات العنيفة، مثل الراديكالية والرومانسية الثورية، تشير تقارير الانتفاضة إلى أن أعلى نسب للمشاركة في التصدي للاحتلال تأتي من المخيمات التي تعيش ظروفاً اجتماعية بائسة، وكذلك تأتي من أحياء المدن الفقيرة جداً وذات الكثافة السكانية العالية، مما يؤكد العلاقة بين الاجتماعي والسياسي في تكوين النظرة العنيفة.
المشاركة والسلوك السياسي في المجتمع الفلسطيني
دراسة اجتماعية في أجزاء: الجزء السادس: المشاركة السياسية للشباب
أسامة خليفة
باحث في المركز الفلسطيني للتوثيق والمعلومات «ملف»
لم تكن المشاركة السياسية للشباب الفلسطيني في مستوى واحد من الفعالية عبر مسيرة الكفاح الوطني، وقد تأرجحت عبر المراحل وعبر المحطات النضالية بين المشاركة السياسية البسيطة والمشاركة السياسية المتقدمة، حيث تعتبر المشاركة متقدمة من ناحيتين: 1- المشاركة في صنع القرار. 2- زخم المشاركة الشبابية (الكم الذي يؤدي إلى النوع) أي ليست فقط هي إحصائية عددية تقدر بكم من الشباب المنجذبين والمنخرطين في الحياة السياسية.
وكان أبرز مشاركة متقدمة في التاريخ الحديث للشعب الفلسطيني منذ الغزوة الصهيونية وما بعد النكبة، المشاركة الحاسمة للشباب في صنع القرار في النصف الثاني من ستينات القرن الماضي، ألا وهو قرار الخروج من عباءة الوصاية العربية، ورفع شعار القرار الفلسطيني المستقل، وتشكيل المنظمات الفلسطينية بالخصوصية الوطنية، ورفع راية الكفاح المسلح وممارسته على أرض الواقع بإطلاق الرصاصة الأولى في الثورة الفلسطينية الحديثة، ذلك الجيل من الشباب الفلسطيني الذي يمكن أن نلخصه في رموزه الوطنية، جيل ياسر عرفات «36» عاماً، ومعه إخوة النضال من المؤسسين في عمر الشباب، صنعوا قرار التأسيس وانطلاقة حركة فتح في بداية العام 1965، ونايف حواتمة في عمر «34» عاماً ومعه رفاقه من جيل الشباب، صنعوا في العام 1969 قرار تأسيس الجناح اليساري المقاوم في الثورة الفلسطينية المتمثل في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وأسس أحمد جبريل عام 1959 جبهة التحرير الفلسطينية، ود.جورج حبش الذي قاد مشاركة شبابية فلسطينية رفيعة المستوى من حيث زخمها في حركة القوميين العرب أفرزت منظمات مكافحة، منظمة شباب الثأر وأبطال العودة.
لم يكن هذا المستوى المتقدم من المشاركة الشبابية في صنع قرار تاريخي مميز شكل انعطافة مهمة في تاريخ الصراع العربي الصهيوني، لولا المشاركة الرفيعة المستوى من الزخم الشبابي عبر اتحاد طلبة فلسطين التي انتجت حركة فتح، والمشاركة بزخم من الشباب الفلسطيني في حركة القوميين العرب، والتي أنتجت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين.
المشاركة الشبابية المتقدمة في صنع القرار التاريخي ذاك، لم يُرسخ ويُثبت تقليداً اجتماعياً سياسياً مكرساً بنصوص قانونية، لا في إطار «م.ت.ف.»، ولا في إطار الفصائل الفلسطينية، فتراجعت المشاركة الشبابية في صنع القرار السياسي بسبب سيادة الفكر السلطوي الأبوي بعد أن تجاوز جيل المؤسسين مرحلة الشباب، وغياب ديمقراطية حقيقية في المؤسسات والاتحادات والأطر الفلسطينية، وتأرجحت المشاركة الشبابية في القضايا الحيوية من حيث زخمها ولم يفرز الكمُ نوعاً قادراً على التغلب على مصادرة القرار الوطني والتفرد بالسلطة.
رغم أن تأطير الشباب وضمهم إلى العمل التنظيمي حظي باهتمام من قبل المنظمات الفلسطينية، فبحثت في أسباب ابتعاد الشباب عن الالتحاق بالفصائل الفلسطينية، ازداد هذا العزوف وضوحاً -ولا سيما في مناطق الشتات- بعد توقيع اتفاقات أوسلو الذي نتج عنها إنهاء الانتفاضة الشعبية الأولى، وفي الضفة والقطاع بسبب الانقسام الداخلي.
في استطلاع أجراه مركز أوراد «10 كانون أول عام 2015» أشار إلى أن ما نسبته 13% فقط من الشباب من عمر «18-25» منضمون للأحزاب السياسية.
يرى 37% بأن الأحداث الحالية (عام 2015) تعبر بشكل رئيس عن إحباط الشباب من فشل عملية السلام واستمرار الاحتلال و24% يرون بأنها تعبر بشكل رئيس عن إحباطهم من دور السلطة في الضفة وحماس في غزة.
وحسب مركز أوراد في استطلاع رأي عينة من الشباب الفلسطيني (الفئة العمرية 16-35 سنة) عبر الإنترنت يرى 80% أن مستويات مشاركة الشباب في صنع القرار الوطني الفلسطيني غير مرضية.
ويعتقد 70% أن عدداً محدوداً من المواطنين يشاركون في الهبة الحالية (عام 2015)، ربما تدل هذه النسبة على مشاركة الشباب دون غيرهم من بين الفئات الأخرى حيث تميزت الهبة بأنها انتفاضة الشباب، مقابل 26% يعتقدون بأنها انتفاضة شعبية واسعة.
اختزلت الفصائل أسباب ابتعاد الشباب عن الانتساب لها مركزة على الجانب النفسي للمشاركة والسمات التي تميز شخصية الشباب، رافضة فكرة أن يكون من أسباب الابتعاد، طبيعة التنظيم، وبرنامج التنظيم، وسياساته الفئوية، وأسلوب تعامله مع الشباب. فالشباب اجتماعي بطبعه يجد راحة كبيرة في أن ينضم ويعيش في وحدات اجتماعية، تستطيع أن تحقق له ذاته، وهي ذات تحب الحرية والشعور بالاستقلالية والمساواة، ومن هنا تبرز أهمية العملية الديمقراطية في الاستقطاب بدلاً من التسلط البيروقراطي، وابتعاد الشباب يؤكد أن المنظمات لم تتعامل مع سماتهم ومزاجيتهم بإيجابية، وهذا يعني ضرورة إيجاد أسلوب جديد في تفهم حاجاتهم وطموحاتهم، وما ينطوي عليه سلوكهم من وجهات نظر، وقيمهم من عناصر ثقافية مستحدثة، ففي حين يعتبر عدم التعامل مع سمات الشباب المتحفز هو تخلي عن روح العصر والتمسك بالبالي والتقوقع والثبات وعبادة القديم، فإن التعامل مع المزاجية لا يعني الرضوخ لها، بل يعني قيادة هذه المزاجية قيادة صحيحة، فالتغير السريع قريب من مزاجية الشباب، والحدث السياسي يتسم بالتغير السريع، لكن هذا التسارع والتغير لم ينعكس في إمكانات جديدة للفكر والعمل تمكن من تفجير الطاقات والقوى الكامنة لدى الشباب، لذا راحوا يبحثون عن الحركة والجديد في مجالات أخرى كالأحداث الرياضية أو حركة الشارع، فأحد أسباب العزلة عند الشباب ناجم عن رفض قواعد السلوك السياسي القديم والتقليدي الذي مارسه الجيل القديم المؤسس، وبقي التنظيم السياسي مصراً على مزاولة هذه التقاليد.
في الجانب الاجتماعي، يتطلب فهم واقع الشباب، والتعامل مع مشكلاتهم الاجتماعية، واتخاذ موقف إيجابي منها بالاهتمام الفعلي من قبل المنظمات، وضرورة تمكين الشباب، ومشاركتهم في صنع القرار، وضمان حقوقهم الأساسية في التعلم والعمل والمشاركة السياسية، بما في ذلك خفض سن الترشيح للمؤسسات المنتخبة ليتساوى مع سن الحق في الانتخاب، ومحاربة ظاهرة بطالة الخريجين، هذا ما سيؤدي إلى اهتمام فعلي من الشباب بنشاطات وفعاليات المنظمات، وكذلك لا بد أيضاً من الاهتمام بالفترة العمرية الأولى للشباب كمرحلة انتقالية تجمع بين الشعور بالغربة والشعور بالقدرة الكلية، والتي إما أن تؤدي للإحساس بالحرية والاستطاعة أو الشعور بالعزلة والغربة، فهم يحاولون الاضطلاع بدورهم وتأسيس هوية ذاتية وتكوين صورة معينة لشخصيتهم، ويتطلب الأمر تنمية قدراتهم وتطوير وعيهم ورفع مستوى الاحساس بالمسؤولية.
الشباب مرحلة خالقة للتوتر لأنهم ميالون إلى الثورة والتمرد والرفض، ونتيجة لذلك لعبوا دوراً بارزاً في إثارة التظاهرات وأعمال الاحتجاج الجماهيري ورفض أوامر الحكم العسكري والتمرد عليها وكانوا سباقين في الانتفاض، وكان الشاب حاتم السيسي أول شهداء الانتفاضة الأولى في يوم 9/12/ 1987. وشهدت الانتفاضة الأولى زخم مشاركة شبابية واسعة، إلا أن أكثرهم خبرة وجدارة لم يصل إلا إلى قيادات ميدانية أو قيادات وسيطة رغم أن الشباب كانوا دينامو الانتفاضة.
تعد مرحلة الشباب من أهم مراحل الإنسان العمرية، إذ تتميز عن غيرها من المراحل العمرية بالاندفاع والحماسة والتطلع للمستقبل والرغبة بالتغيير والتطوير والتحرر، انعكس هذا في الانتفاضة بالإصرار على مواصلة المواجهات اليومية مع المستوطنين وجيش الاحتلال، واستخدام المتاح من الوسائل النضالية للرد على جرائم القتل والإعدام الميداني، ساعدهم في ذلك امتلاك الشباب طاقات وقدرات خلاقة وروح كفاحية عالية، واستعداد عال للتضحية، بالإضافة إلى سمات الشجاعة، جعلت الجيل الحالي من شباب فلسطين، هو من صنع الانتفاضة الحالية، بشكليها الشعبي والمسلح فأطلق عليها تسمية «انتفاضة الشباب»، ويزداد يوماً بعد يوم زخم المشاركة الشبابية، في كل مدن ومخيمات و بلدات الضفة ولاسيما في جنين ومخيمها، نابلس وبلدتها القديمة، يقبل شبان عرين الأسود وكتيبة جنين وغيرهما على الاشتباك مع جنود الاحتلال، دون خوف من اعتقال أو إصابة أو استشهاد، لقد تطور العمل النضالي الشبابي، من طابعه الفردي، باستخدام الوسائل المتاحة من عمليات الطعن بالسكاكين، والدهس بالسيارات والآليات، وصولاً إلى استخدام الأسلحة النارية في مواجهة جنود الاحتلال ومستوطنيه، فيما أطلق عليه الاحتلال مصطلح «الذئاب المنفردة»، حولت حياة المستوطنين إلى رعب دائم وتفكير بالرحيل. المسار الكفاحي للانتفاضة الشبابية أكد أن الشارع هو الأقدر على اختيار الأسلوب المناسب ليعبر عن مشاعره ومواقفه السياسية، كما أكد على أهمية الدور المميز للشباب في تفجيرها، الذي جاء عفوياً ودون قرار مسبق من أحد، رغم الأغلبية الواسعة المنخرطة في هذا الحراك الشبابي هم من مناضلي وأبناء الفصائل الفلسطينية. ومن الواضح أن العفوية التي انطلقت بها انتفاضة الشباب هي نتاج لواقع معين في الحالة الوطنية ما زالت هذه الحالة تفتقر إلى الحزب الثوري الذي بإمكانه أن يأخذ على عاتقه إطلاق استراتيجية نضالية جديدة يستطيع من خلالها أن يؤطر تحالفات مستقرة قادرة على تحقيق مكاسب وطنية هامة، فالسؤال الأهم: هل تتمكن القوى الوطنية والديمقراطية واليسارية من تحويل هذه العفوية إلى عمل منظم؟. عبر بناء لجان التنسيق المحلية، وأطلاق شعارات للانتفاضة ترسم أهدافها في الاستقلال وضمان حق العودة، وتوسع إطار المشاركة فيها، بحيث تنضم إليها فئات اجتماعية جديدة، لتتحول من انتفاضة شبابية إلى انتفاضة شعبية شاملة، تحافظ فيه على دور الشباب في قيادتها، وصنع قراراتها، وصياغة بياناتها، مما يشكل منعطفاً يفرض على القيادة الرسمية تبني شعارات هذه الانتفاضة وفقاً لاستراتيجية كفاحية جديدة.
حظي الحراك الشبابي بتعاطف واحتضان واسعين من أغلبية شرائح المجتمع، إنما هذا التعاطف لم يتحول إلى انخراط مباشر في انتفاضة الشباب من قبل قطاعات اجتماعية واسعة ذلك الانخراط الذي يضمن استمرارية زخم الانتفاضة الشبابية، ويشكل الشرط الرئيس لانتقالها إلى مرحلة الانتفاضة الشعبية الشاملة.
بعض الشرائح الاجتماعية المحدودة ما زالت تعبر عن ترددها إزاء استمرار الانتفاضة الشبابية، وتخوفها من تأثيرات المواجهة المستمرة المتواصلة على مصالحها الضيقة والامتيازات التي يكفلها لها واقع التعايش مع الاحتلال، الذي انعكس في توجهات قيادة السلطة بمحاولة احتواء انتفاضة الشباب بحجة الحفاظ على الدم الفلسطيني، وكأن الدم الفلسطيني لم يكن يسفك إلا بعد أن انتفض الشباب ضد جرائم الاحتلال، وتواصل القيادة الرسمية التعامل مع انتفاضة الشباب من موقع المسايرة على مضض لحيلولة دون تطورها وتصاعدها حتى لا يضع هذه القيادة أمام خيارات صعبة، وترافق هذا الموقف الاحتوائي مع محاولات الاستثمار السياسي قصير النفس لهذا الحراك في تعزيز الموقف التفاوضي للسلطة، في إطار استمرار الرهان الخاسر على دور الولايات المتحدة في تليين التعنت الإسرائيلي وفك استعصاء العملية التفاوضية.
نجح الحراك الشبابي حتى الآن في شل محاولات احتوائه، ولعب إقدام الطلائع الشبابية للانتفاضة وتصميمها دوراً حاسماً في ذلك، فهي عبرت عن مستوى متقدم من النضج والوعي، ووجهت رسائل شديدة الوضوح إلى قيادات فصائلها بضرورة التخلي عن الحسابات الخاصة والمصالح الفئوية الضيقة والارتقاء إلى مستوى المسؤولية، بتوحيد الصف من أجل الانخراط في انتفاضة الشباب وتطويرها إلى انتفاضة شاملة، مهددة بتعميق الفجوة بين الشارع وبين هذه القيادات إذا لم ترتق إلى مستوى مسؤولياتها.
إن المهمة الرئيسية للقوى الوطنية في المرحلة الراهنة تتمثل أولاً في تعبئة قواها وزجها للانخراط بفعاليات الانتفاضة الشبابية، بهدف تعزيز زخمها وضمان استمرارها، والعمل بدأب على توسيع المشاركة الجماهيرية، وتأمين انخراط أوسع قطاعات المجتمع في هذا الحراك، باعتبار ذلك يشكل المفصل الحاسم لتحويل الانتفاضة الشبابية إلى انتفاضة شاملة، إن هذا يملي على عموم الحركة الوطنية الفلسطينية البحث عن سبل تطوير الهبة الشبابية، بتشكيل القيادة الوطنية الموحدة للانتفاضة بتمثيل شبابي وازن، عبر مجالس الطلبة في جامعات الضفة والقدس، والاتحادات الشعبية، والنقابات المهنية، يكون لها أذرعها الضاربة في المحافظات والمدن والقرى والمخيمات، تشكل غرفة العمليات السياسية التي ترسم للانتفاضة استراتيجيتها، وسياساتها وتكتيكاتها ومهماتها الكفيلة بتوحيد نضالات شعبنا وتطويرها وإدامتها ، وتوفير عناصر صمودها وثباتها.
أطلــقت الحكومــة الفلسطينية الثامنــة عشــرة، برئاســة د. محمــد اشــتية، «الخطــة الوطنيــة للتنميــة» 2021-2023: التي تتمحــور حــول «الصمــود المقــاوم والانفـكاك، والتنميـة بالعناقيـد نحـو الاسـتقلال»، وتهـدف لخلــق اقتصــاد مقــاوم محصــن مــن الاختــراق والتبعيــة، ويعــزز صمــود النــاس فــي أرضهــم وبلدهــم ويســاهم فــي إنجـاز الاسـتقلال. بتشـجيع الإنتــاج الصناعــي والزراعــي والســياحي التنافسي بين المحافظات، كما تهدف إلى الحــد مــن البطالــة ومحاربــة الفقــر، وتعزيــز دور الشــباب، وتمكين المــرأة، بما يضمن السير نحـو الاسـتقلال، بمـا أن الاقتصـاد هـو رافعـة للسياسـة، وهـذا يعنـي تجييـر الاقتصـاد وعمليـة التنميـة بقطاعاتهـا المختلفـة لخدمـة البرنامـج التحـرري.
وجاء في الخطة الوطنية للتنمية 2021-2023 عن دور قطاع الشباب فــي المســاهمة بالتغييــر المجتمعــي، ومسـاهمته القيمـة فـي العمـل التطوعـي، ورأت أن الشـباب الفلسـطيني مـا زال يعانـي مـن ضعـف المشـاركة المجتمعيـة بصفـة عامـة، ورأت أن دور الشـباب أصبـح أكثـر انحسـاراً ليقتصـر علــى المســاهمة بتنفيــذ الحملات المجتمعيــة، وأنشــطة العمــل التطوعــي، وغيرهــا مــن الحمـلات، وقدرت أن المسـاحة المخصصـة للمشـاركة السياسـية للشـباب تعتبـر محـدودة، وتقتصــر فــي الكثيــر مــن الحــالات علــى مجالــس الطلبــة فــي الجامعــات، والتــي هــي عبــارة عــن امتــداد للأحــزاب السياســية الوطنيــة، وغالبــاً مــا تكــون أرضيــة لاســتمالة السياســيين مسـتقبلاً.
إذاً ما العمل؟. السؤال المطروح وطنياً: هل «الخطــة الوطنيــة للتنميــة» 2021-2023 الصادرة عن الحكومة الفلسطينية قدمت مشروعاً مؤدياً للارتقاء بدور الشباب السياسي؟ فيما يتعلق بالتعليم جاء في «الخطــة الوطنيــة للتنميــة» أن المســؤولية عــن نوعيــة التعليــم وجودتــه لا تقــع علــى عاتــق الدولــة بصفــة حصريـة، فمـا يزيـد علـى 30% مـن المعلميـن الفلسـطينيين يعملـون، وحوالـي نصـف مليـون طالــب يدرســون، فــي المــدارس التابعــة لوكالــة الأمــم المتحــدة لغــوث وتشــغيل اللاجئيــن(الأونـروا) أو فـي المـدارس الخاصـة. وبنـاءً علـى ذلـك، ينبغـي أن تسـتند اسـتراتيجية قطـاع التعليــم إلــى عمليــة تشــاركية تضمــن الاتســاق والتكامــل والتمايــز بيــن جميــع المؤسســات التعليميــة، وهنا تقع بالتحديد مسؤولية الحكومة في إدارة هذه التشاركية، وخاصة في محاولة فرض برامج غير وطنية تحت مسمى نشر الكراهية في مدارس الأونروا، لذا الأمر لا يقتصر فقط على حمايـة المناهـج الفلسـطينية فـي القـدس والتصـدي لسياسـة الأسـرلة في مدارسها، بل يمتد إلى خارج المدينة المقدسة.
وتهــدف الحكومــة الفلسطينية في خطتها إلــى توفيــر مشــاريع للشــباب، فــي مجــالات الزراعــة، والحــرف، والبرمجــة والتطبيقــات الإلكترونيــة، والتحــول فــي التعليــم، جزئيــاً، نحــو التعليــم المهنــي. وهــذا كلــه مـن شـأنه أن يحقـق مجموعـة أهـداف: أولهـا، الارتقـاء بالتعليـم المجـرد، الفلسـفة، والعلـوم الإنسـانية، والاجتماعيـة، بجعلهـا أكثـر تخصصـاً، وأقـل جماهيريـة، مـا يعـزز نوعيـة التعليـم فـي هـذه المجـالات، ويقلـل مـن الضغـط علـى سـوق العمـل فيهـا، مـا يعطـي الفرصـة للكفـاءات النوعيـة فيهـا. ثانيـاً، زيـادة عـدد العامليـن فـي مشـاريع ذاتيـة، ومهنيـة، مختلفـة. ثالثـاً، يـؤدي تغييـر نمـط ملكيـة أماكـن العمـل ومصـادر الدخـل، لزيـادة تمكيـن الأفـراد، وحريتهـم بعيـداً عـن الارتبـاط بالوظيفـة العامـة، أو المانـح الخارجـي.
الأهم من ذلك كله هو الانفكاك من التبعية للاقتصـاد الاسـرائيلي والتخلص من سطوة الشيكل الإسرائيلي، والخروج من بروتوكول باريس الاقتصادي، وإيجاد البدائل للعمال الفلسطينيين العاملين في المستوطنات وفي داخل الخط الأخضر عن سوق العمل الإسرائيلي، وحماية المنتج الوطني، ومحاربة الاعتماد على المنتج الإسرائيلي، وإيجاد البدائل من السوق المحلية أو العربية أو العالمية.
ورأت الخطة أن تعزيز النشأة السوية للطلبة تتطلب تجـاوز عمليـة التعليـم من المنظـور الضيـق للدراسـة الصفيـة، وبهـذا تولـي هـذه الخطـة اهتمامـاً خاصــاً بصحــة الطلبــة بمفهومهــا الشــمولي، وتعزيــز مشــاركة الطلبــة الفاعلــة فــي الحيــاة المدرسـية والمجتمعيـة وتعلمهـم للمهـارات الحياتيـة اللازمـة لصقـل شـخصيتهم بجوانبهـا المختلفــة، بمــا يشــمل أيضــاً التركيــز علــى القيــم الأخلاقيــة والإنســانية وتجذيــر الانتمــاء والوعــي بالروايــة الفلســطينية.
الحديث عن التعليم والدور السياسي للشباب لم يترافق مع موازنات محددة لهذه الأهداف، هذا في الأراضي المحتلة عام 1967، فكيف يكون الحال في الشتات باعتباـر دولــة فلســطين الوطــن الــذي يحتضــن جميــع الفلســطينيين المقيميــن داخــل حدودهـا وخارجهـا، بمـا فيهـا التجمعـات المعزولـة مـن جـراء ممارسـات الاحتـلال الاسـرائيلي؟.





