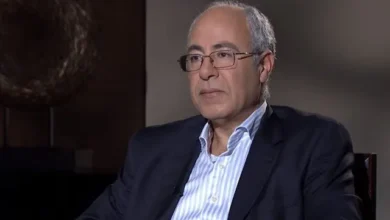من الصراع إلى الحوار: نحو سلام عادل ومستدام.. بقلم/ المحامي علي أبو حبلة

في ظل الصراع الفلسطيني–الإسرائيلي الممتد منذ عقود، والذي خلّف مآسي إنسانية عميقة وكرّس انعدام الثقة بين الشعبين، تبرز مبادرات مدنية تحاول كسر منطق الصراع والانتقال من ثقافة الصراع إلى ثقافة الحوار. من بين هذه المبادرات، تكتسب تجربة “مقاتلون من أجل السلام” دلالة خاصة، إذ تجمع فلسطينيين وإسرائيليين كانوا يومًا جزءًا من دوائر الصراع ، قبل أن يختاروا نبذه والإيمان بأن الحوار والاعتراف المتبادل هما السبيل الوحيد لتضميد الجراح وبناء مستقبل آمن للطرفين.
لقد أثبتت التجربة التاريخية أن إدارة الصراع أو التعويل على القوة العسكرية لم تحقق الأمن ولا الاستقرار، بل عمّقت دائرة الخوف والكراهية، وأجّلت أي أفق حقيقي للسلام. ومن هنا، فإن أي معالجة جادة للقضية الفلسطينية لا يمكن أن تكتفي بالحلول الجزئية أو المؤقتة، بل يجب أن تنطلق من أسس العدالة وحقوق الإنسان والكرامة الإنسانية، باعتبارها القاعدة الصلبة لأي سلام قابل للاستمرار. فلا أمن حقيقي لإسرائيل دون إنصاف الفلسطينيين، ولا كرامة للفلسطينيين دون إنهاء الاحتلال وضمان حقهم في تقرير المصير.
يمثل حل الدولتين الإطار الأكثر واقعية لتحقيق هذا الهدف، شريطة أن يكون قائمًا على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، لا على موازين القوة وحدها. فإقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة إلى جانب دولة إسرائيلية آمنة ومعترف بها دوليًا ليست ترفًا سياسيًا، بل ضرورة إنسانية وأمنية لضمان الاستقرار الإقليمي. إن التعايش بين الشعبين يجب أن يتحول من شعار سياسي إلى ممارسة يومية، تبدأ من التعليم والإعلام، وتصل إلى أماكن العمل والحياة العامة، بما يرسخ قيم الاحترام المتبادل ويبدد منطق الإقصاء والتهديد المتبادل.
وفي هذا السياق، تشكل إدانة العنف والانتهاكات بكافة أشكالها ركيزة أساسية لا يمكن تجاوزها. فلا سلام مع سياسات التطهير العرقي أو التمييز العنصري أو الاعتداء على المدنيين. كما أن رفض معاداة السامية، بوصفها شكلًا من أشكال العنصرية، يجب أن يقترن برفض التحريض ضد الفلسطينيين وإنكار حقوقهم. إن مواجهة خطاب الكراهية والتطرف، والاعتراف بجرائم الماضي والتعامل معها بمسؤولية وشفافية، شرطٌ لبناء الثقة وفتح صفحة جديدة قائمة على الاحترام المتبادل.
يلعب الدور الإقليمي أهمية محورية في هذا المسار، إذ تمتلك دول عربية مؤثرة، وفي مقدمتها مصر والسعودية وقطر والإمارات والأردن، القدرة على دعم مسار السلام، ليس فقط عبر الوساطة السياسية، بل من خلال التأثير في الرأي العام وتشجيع ثقافة التعايش. ويتطلب ذلك الانتقال من الدبلوماسية التقليدية إلى دبلوماسية مجتمعية وإعلامية تبرز أن قيام الدولة الفلسطينية ليس تهديدًا لأمن إسرائيل، بل عنصر استقرار، وأن التعايش السلمي يفتح آفاق التنمية والأمن المشترك.
أما المجتمع الدولي، فهو مطالب بتجاوز الاكتفاء بالبيانات، والانتقال إلى آليات عملية تجمع بين الحوافز والضغوط. فالدعم الاقتصادي وإعادة إعمار غزة، وتحفيز الاستثمارات في الأراضي الفلسطينية، تشكل أدوات حقيقية لبناء الثقة. وفي المقابل، فإن محاسبة أي طرف ينتهك القانون الدولي أو يقوض فرص السلام تبقى ضرورة لا غنى عنها لإنهاء سياسة الإفلات من العقاب.
وعلى صعيد القيادات السياسية، تقع مسؤولية تاريخية تتطلب شجاعة أخلاقية قبل أن تكون سياسية. فالتخلي عن خطاب التحريض، وبناء أنظمة حكم قائمة على المساءلة واحترام حقوق الإنسان، وفتح مسارات حوار واسعة مع المجتمع المدني، تمثل شروطًا أساسية لمنع الانزلاق مجددًا إلى دوامة العنف. كما أن وقف الاستيطان والعنف في الضفة الغربية، ورفع الحصار عن غزة، والشروع الجاد في إعادة إعمارها، ليست مطالب إنسانية فحسب، بل استحقاقات سياسية لا غنى عنها لتهيئة بيئة قابلة للتعايش.
إن التعايش في إطار حل الدولتين ليس اتفاقًا عابرًا بين حكومات، بل مشروع ثقافي وإنساني طويل الأمد، يتطلب الاستثمار في الأجيال القادمة وتعليم قيم التسامح والعدالة منذ الصغر، وتشجيع المبادرات الشبابية المشتركة التي تعزز الثقة وتكسر الصور النمطية. فعندما يرى الفلسطيني والإسرائيلي نماذج عملية للتعاون في ظل بيئة آمنة، يتحول السلام من فكرة مجردة إلى واقع ملموس.
ختامًا، إن الطريق من الصراع إلى الحوار طريق شاق، لكنه الطريق الوحيد نحو سلام عادل ومستدام. نبذ العنف، والاعتراف المتبادل بالحقوق، والتمسك بحل الدولتين، ووقف الانتهاكات، وتفعيل الدورين الإقليمي والدولي، تشكل جميعها عناصر مترابطة لا يمكن فصلها. وفي هذا الإطار، يصبح السلام مسؤولية جماعية وأخلاقية، تتجاوز الحكومات إلى الشعوب، ليغدو التعايش المشترك قاعدة ثابتة تعكس الكرامة والعدل والإنسانية، وتؤسس لمستقبل آمن للشعبين والمنطقة بأسرها.